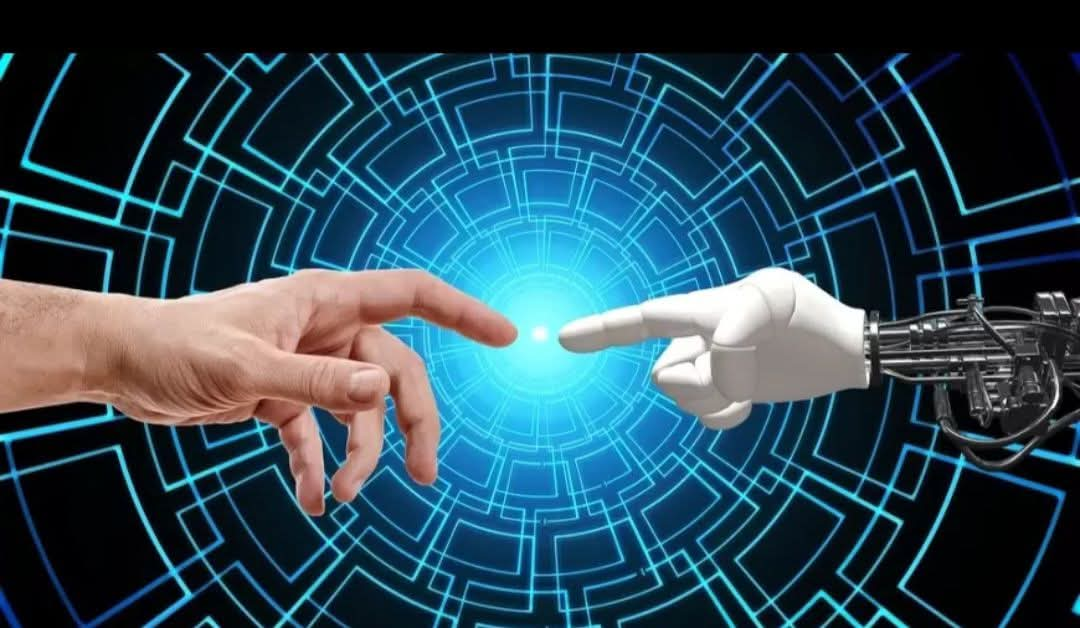بقلم : جمال حشاد
يُعَدّ العلم حجر الأساس الذي تُبنى عليه نهضة الشعوب وتقدم الأمم، فهو القوة الخفية التي تحرك عجلة الحضارة، وتصنع الفارق الحقيقي بين المجتمعات المتقدمة وتلك التي ما زالت تسعى للحاق بركب التطور. وليس من المبالغة القول إن تاريخ البشرية هو في جوهره تاريخٌ للعلم، فكل قفزة حضارية كبرى ارتبطت ارتباطًا وثيقًا باكتشاف علمي أو تطور معرفي غيّر طريقة تفكير الإنسان ونظرته إلى العالم.
في حياة الشعوب المتقدمة، لا يُنظر إلى العلم على أنه ترف فكري أو نشاط نخبوي يقتصر على المختبرات والجامعات، بل يُعد أسلوب حياة ومنهج تفكير.
فالعلم حاضر في تفاصيل الحياة اليومية:
في التخطيط العمراني، وفي أنظمة التعليم، وفي وسائل النقل، وفي الرعاية الصحية، وحتى في طريقة إدارة الوقت والموارد. إن الشعوب التي أدركت قيمة العلم جعلته بوصلة توجه قراراتها الكبرى، فاستثمرت في البحث العلمي، وكرّمت العلماء، وربطت التقدم الاقتصادي بالابتكار والمعرفة.
يلعب العلم دورًا محوريًا في بناء الاقتصاد القوي للدول المتقدمة. فاقتصادات هذه الدول لم تعد تعتمد فقط على الموارد الطبيعية، بل أصبحت قائمة على اقتصاد المعرفة، حيث تُعد الأفكار والاختراعات ورأس المال البشري أثمن من النفط والمعادن. ومن خلال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، استطاعت هذه الشعوب أن تخلق صناعات جديدة، وتزيد من الإنتاجية، وتنافس عالميًا في مجالات دقيقة مثل الذكاء الاصطناعي، والطب الحيوي، والطاقة المتجددة. وهكذا أصبح العلم محركًا رئيسيًا للنمو والاستقرار الاقتصادي.
ولا تقل أهمية العلم في المجال الصحي، حيث أسهم في إطالة متوسط عمر الإنسان، والحد من انتشار الأمراض، وتحسين جودة الحياة. فالشعوب المتقدمة استطاعت، بفضل التقدم العلمي، تطوير اللقاحات، واكتشاف الأدوية، واستخدام التكنولوجيا في التشخيص والعلاج المبكر. وقد ظهر هذا الدور بوضوح في مواجهة الأوبئة العالمية، حيث كان العلم السلاح الأقوى الذي مكّن هذه الدول من حماية شعوبها وتقليل الخسائر البشرية والاقتصادية.
أما في مجال التعليم، فإن العلم يُشكّل العمود الفقري للأنظمة التعليمية في الدول المتقدمة. فالتعليم هناك لا يقوم على الحفظ والتلقين، بل على البحث، والتجربة، وتنمية التفكير النقدي والإبداعي. ويُربّى الفرد منذ صغره على احترام العلم، وطرح الأسئلة، والبحث عن الأدلة، مما يخلق أجيالًا قادرة على الابتكار وحل المشكلات. وهذا النوع من التعليم لا يصنع موظفين فقط، بل يصنع علماء ومفكرين وقادة مستقبل.
العلم يسهم في ترسيخ قيم التقدم الاجتماعي والإنساني:
فالعلم يعزز ثقافة الحوار، ويُضعف الخرافة، ويواجه الجهل بالتفسير المنطقي والفهم العميق. والمجتمعات التي تسود فيها العقلية العلمية تكون أكثر تسامحًا، وأكثر قدرة على تقبّل الاختلاف، لأن العلم يقوم على الدليل لا على التعصب، وعلى التجربة لا على الانغلاق. ولهذا نجد أن الشعوب المتقدمة علميًا هي غالبًا الأكثر احترامًا لحقوق الإنسان، والأكثر التزامًا بقيم العدالة والمساواة.
دور العلم في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة:
فقد أدركت الشعوب المتقدمة أن التقدم الحقيقي لا يكون على حساب الطبيعة، فوظّفت العلم لإيجاد حلول لمشكلات التلوث، وتغير المناخ، ونقص الموارد. ومن خلال البحث العلمي، طوّرت هذه الدول مصادر طاقة نظيفة، وأساليب زراعة ذكية، وتقنيات تقلل من الهدر وتحافظ على حق الأجيال القادمة في الحياة الكريمة.
وفي الختام، يتضح أن العلم ليس مجرد أداة للتقدم، بل هو روح الحضارة الحديثة وشرط أساسي لنهضة الشعوب. فكل أمة جعلت العلم أولوية في حياتها، حصدت ثماره أمنًا، وازدهارًا، واستقرارًا. أما الشعوب التي أهملت العلم، فقد حكمت على نفسها بالتبعية والتأخر. ومن هنا، فإن الطريق إلى المستقبل يبدأ من الإيمان بالعلم، والاستثمار في العقل الإنساني، وبناء مجتمع يقدّر المعرفة ويجعلها أساسًا لكل تقدم.