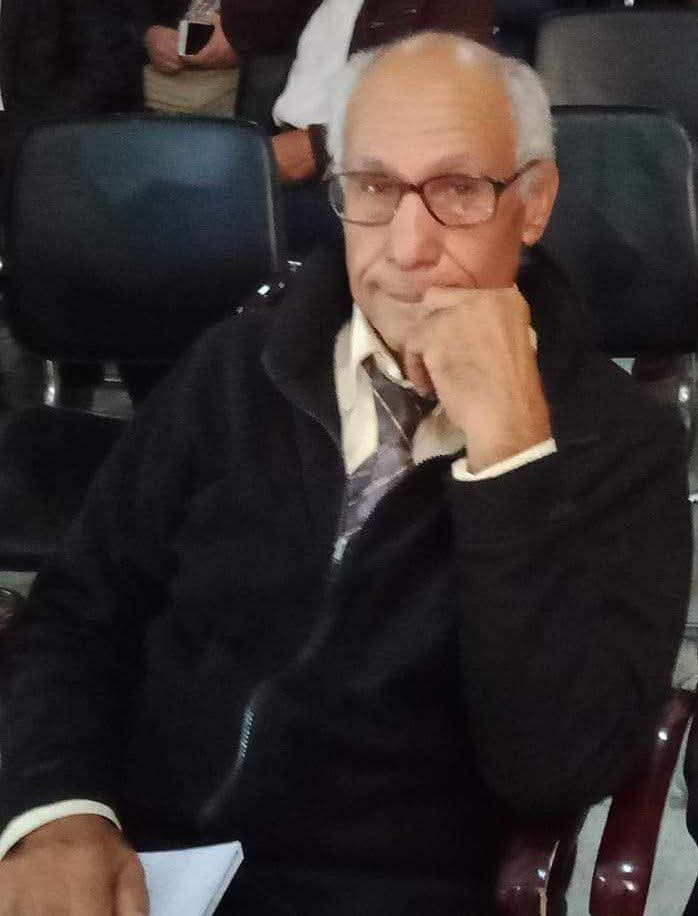عبد الحفيظ يوننس
هي مقالة كتبتُها ونشرتُها سنة 2006، يوم احتضنت مدينة بسكرة، جنوب شرق الجزائر، الملتقى الدولي للشعر النسوي. قلتُ آنذاك إنّ الجمهور البسكري سيعيش أيّامًا في رحاب الكلمة؛ تلك التي هي ثروة الأدب وزاد الأديب. وبعبير أدق: الشعر… أو ما يُسمّيه البعض شعرًا نسويًا.
والشعر، في جوهره، غلبةُ النور على العتمة، والحق على الباطل. هو ابتسامة الطفل ودمعة الثكلى، تورّد وجنة العذراء وتجاعيد وجه الشيخ. هو جمال البقاء وبقاء الجمال، لذّة التمتّع بالحياة، والرعشة أمام وجه الموت.
الشعر حبّ وبغض، نعيم وشقاء، ميلٌ جارف وحنينٌ دائم إلى أرض لم نعرفها ولن نعرفها، انجذابٌ أبديّ لمعانقة الكون بأسره، والاتحاد مع ما فيه من جماد ونبات وحيوان. هو ذاتٌ روحية تتمدّد حتى تلامس أطرافها الذاتَ الكونية.
وبالإجمال، الشعر هو الحياة: باكية وضاحكة، ناطقة وصامتة، مولولة ومهلّلة، شاكية ومسبّحة، مقبلة ومدبرة.
غير أنّ الشعر، بوصفه تعبيرًا فنيًا، كثيرًا ما جرى تصنيفه وفق المتحيّز الذي يحدده الجنس. لكنّ كثافة وتنوّع الإنتاج الإبداعي النسائي في السنوات الأخيرة، وفي مختلف الميادين، كفيلان بأن يجعلا التعامل معه معطًى بديهيًا، غير مثير للتساؤل أو الدرس بوصفه “نسويًا”. وربما، مع مرور الوقت، نتوقّف عن نعت هذا الإبداع بالنسائية أصلًا.
وهنا يبرز السؤال:
هل يصبح التعبير الفني، بكل أشكاله، حلًّا لإشكالية اللغة المذكرة؟
وهل يحتاج الشعر، أو السينما، أو الرواية، إلى تصنيف مذكّر/مؤنث؟
هذا السؤال يتردّد منذ مدة في المنتديات التي تنسب إلى نفسها صفة التخصّص في قضايا المرأة، حيث يبرز شبه رفضٍ لمواصلة الحديث عن المرأة بوصفها حالة خاصة، مقابل رغبة متزايدة في الحديث عن الإبداع نفسه، والتعامل معه وفق نوعيته وجودته وما يقدّمه، بغضّ النظر عن جنس المبدع أو المبدعة.
لم تعد المرأة تطلب أن تُعامَل بعطف أو تساهل أو تشجيع خاص لأنها امرأة، أو لأنها “ضعيفة” أو “غير قادرة”… فعندما نقرأ، مثلًا، للشاعرة نازك الملائكة، تلك المجدّدة التي أغنت الشعر العربي في واحدة من أزهى مراحله، لا نقرأ شعرها من زاوية المذكر والمؤنث، بل نقرؤه بوصفه أدبًا مبدعًا ومعبرًا، وكفى.
فالتجربة الإنسانية لا تتجزأ، ومن ينجح في التعبير عنها، وملامسة بعدها الإنساني العميق في كائن بشري واحد، قادر على أن يمسّ الآخرين، مهما اختلفت قومياتهم أو ثقافاتهم أو أجناسهم. وكما قال العقاد:
«الشعر من نَفَس الرحمن».