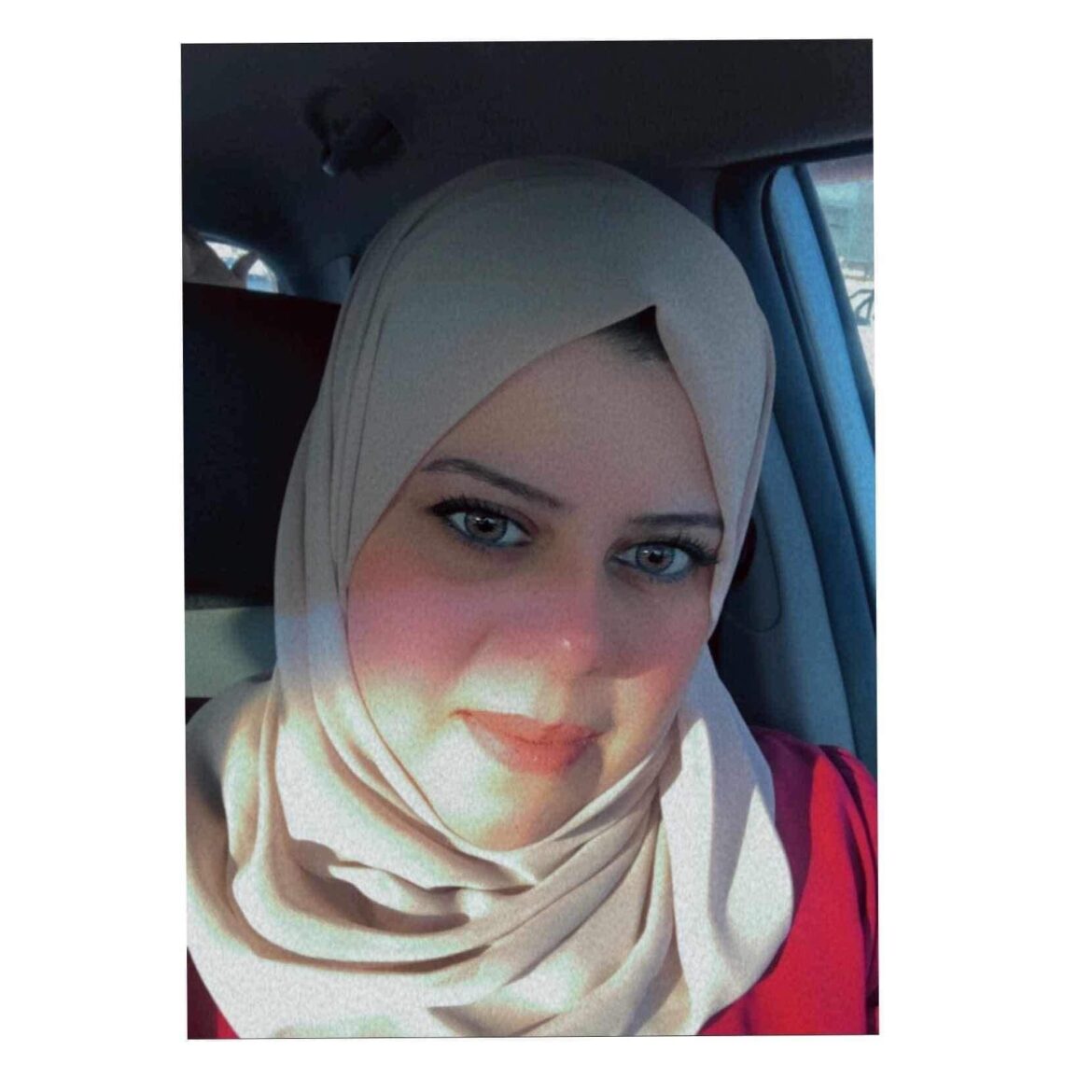نادرًا ما أتفاعل مع الترندات، ولا أكترث كثيرًا بالقضايا التي أشعر أنها مفتعلة أو مقصود بها إثارة الجدل وصناعة بلبلة عابرة تتجدد مع كل قضية. لكن هناك قضايا من نوع آخر؛ لا تطرق باب القلب فحسب بل تقرع أبواب العقل بعنف، وتفرض نفسها على الضمير الإنساني فرضًا.
قصص القتل والعنف ضد الزوجات والنساء عمومًا، في مجتمع تدنّت فيه القيم إلى الحد الذي أصبح فيه الإنسان بلا ثمن، تأتي في مقدمة هذه القضايا. فحين يُستهان بالحياة الإنسانية، تصبح الجريمة أمرًا اعتياديًا، بل ومُبررا في نظر البعض.
تلك النظرة الدونية جعلت من المرأة جزءًا من متاع الرجل، كأي شيء من ممتلكاته، يعتقد أنه حُرّ التصرف فيه، حتى لو بلغ الأمر حد إنهاء حياتها. وهي نظرة لا تنبع من قوة، بل من فقر أخلاقي وثقافي، ومن عجز عن فهم معنى الشراكة الإنسانية، والكرامة، والمسؤولية.
تناول أو التعامل مع قصص مخزية كهذه مُرهِق ومؤلم ومحبط؛ لأنها لا تكشف عن جريمة فردية معزولة، بل تفضح بنية فكرية مريضة ما زالت تُبرر العنف، وتمنحه غطاءً اجتماعيًا وأخلاقيًا زائفًا. وبنظرة سريعة إلى عينة من التعاملات السائدة تجاه المرأة، نجد أن المشكلة لم تعد أحداثًا استثنائية، بل نمطًا متكررًا يُعاد إنتاجه يوميًا، يُطبِّع مع الإهانة، ويحوّل الجريمة إلى خلاف أسري، والقتل إلى انفعال لحظي!
الأخطر من الجريمة نفسها هو هذا التواطؤ الصامت؛ تواطؤ الخطاب، والعادات، وبعض التفسيرات المغلوطة التي تُستخدم لشرعنة السيطرة، لا لحماية الإنسان. ففي مجتمعات يغيب فيها الوعي، يُطالَب الضحية بالصمت، وتُحاسَب المرأة على نجاتها إن نجت، وعلى موتها إن قُتلت.
العنف ضد المرأة ليس قضية نسوية معزولة، ولا شأنًا عائليًا خاصًا، بل هو مؤشر خطير على انهيار منظومة القيم في المجتمع ككل. فالمجتمع الذي لا يحمي أضعف حلقاته، ولا ينتصر لضحاياه، هو مجتمع يُهيّئ نفسه لمزيد من العنف، ومزيد من الانحدار.
أصبح الحديث عن هذه الجرائم ليس رفاهية، ولا ركوبًا لموجة جدل، بل واجب أخلاقي وإنساني. فالصمت هنا شراكة غير مباشرة، والتبرير جريمة موازية، والتجاهل شكل آخر من أشكال العنف.
وحتى تتوقف هذه الدائرة المظلمة، لا بد من مواجهة جذرية؛ وعي حقيقي، تعليم يحترم الإنسان، خطاب ديني وثقافي مسؤول، وقانون لا يساوم على الدم. فحياة المرأة ليست ملكًا لأحد، وكرامتها ليست منحة، ووجودها ليس هامشًا بل هي إنسان كامل، وحين يُقتل الإنسان، يُقتل المجتمع معه.
قال تعالى:(مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جميعا)
تلك الجرائم ترتكب تحت تفسيرات معوجة لبعض المتحدثين باسم الدين تارة وبعض المتبنين لأعراف مجتمعية ومتوارثة تارة أخرى.
ورغم تكرار تلك المآسي لم يقف المتسببون فيها وقفة إنصاف لمحاسبة النفس على خطابهم الدموي للبسطاء، ولم يُخضعوا خطابهم للمراجعة أو المحاسبة، بل استمروا في ضخ خطاب ملوّث يبرّر العنف، ويمنح القتلة مبررات جاهزة، ويغذّي وعيًا هشًا لدى البسطاء. فعوضا عن أن يكون الفكر أداة تصحيح وإنقاذ، تحوّل في بعض السياقات إلى شريك صامت في الجريمة، يكرّس التخلف، ويعيد إنتاج المأساة، ويؤجّل المواجهة الضرورية مع حقيقة مؤلمة .. أن العنف لا يولد من فراغ، بل من خطاب فاسد، وفهم أعور، وصمتٍ طويل عن مراجعة الذات.
فإلى متى يستمر هذا الطغيان وإلى متى نطلق سراح القتلة؟!