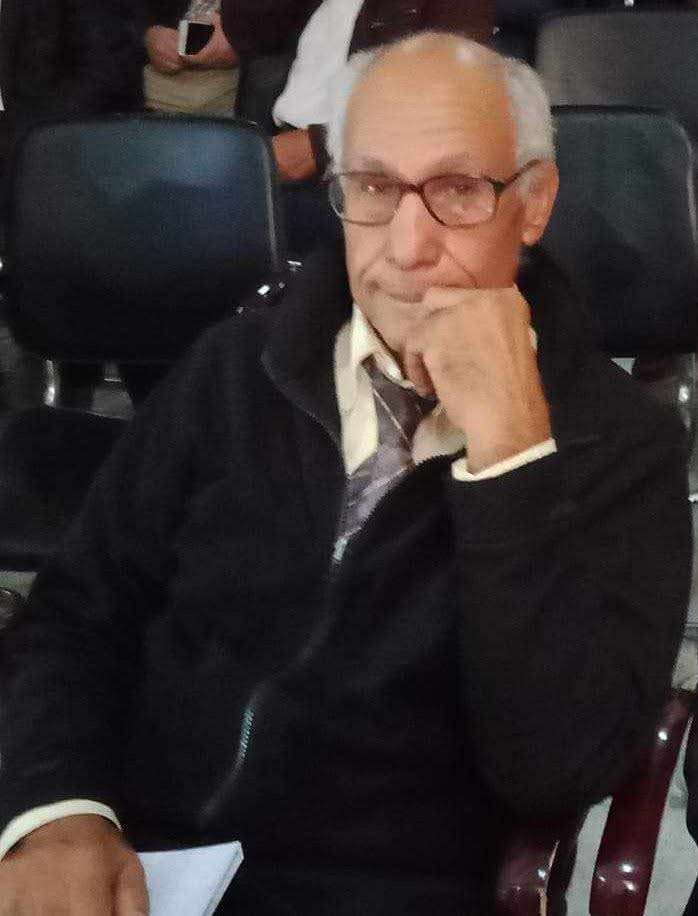بقلم: عبد الحفيظ يونس
عندما خلق اللهُ آدم، وقال للملائكة إنه جاعلٌ في الأرض خليفة، تساءلوا ـ تساؤل فهمٍ لا اعتراض ـ قائلين:
﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾،
فجاء الردّ الإلهيّ العميق:
﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾.
هذه الآية، في جوهرها، ليست سردًا غيبيًا فقط، بل مفتاحٌ لفهم معنى الاستخلاف، ومعيار التفاضل بين البشر. فالله لم يمنح الإنسان الأرض لأنه أفضل ادّعاءً، بل لأنه أقدر على التعلّم، والبناء، والارتقاء، وتحويل الغريزة إلى وعي، والفوضى إلى نظام، في إطار التكليف والمسؤولية.
ومن هذا المنطلق، فإن الانتماء الحقيقي لأي أمة لا يُقاس بالأسماء ولا بالشعارات، بل بالفعل الحضاري. فالأمم التي تقترب من مقاصد الاستخلاف هي تلك التي خدمت الإنسان، وراكمت العلم، وصانت الكرامة البشرية، وأسهمت في نفع البشرية جمعاء؛ سواء كانت في الشرق أو الغرب، في الصين أو الولايات المتحدة أو الهند أو بعض دول أوروبا، دون أن يعني ذلك تحقق الاستخلاف الشرعي الكامل الذي لا يقوم إلا على الإيمان والعدل والطاعة.
أما الادّعاء الفارغ بالانتساب لأمةٍ ما، دون قراءة أو إنتاج أو أخلاق عامة، فلا يصنع أمة ولا إنسانًا. فالأمة التي لا تقرأ، ولا تُعمل عقلها، ولا تحترم إنسانها، تبقى حبيسة منطق الغريزة، مهما بالغت في ترديد الشعارات الدينية أو القومية. وهي، إلى اليوم، من أكثر الأمم إفسادًا في الأرض، لا عجزًا بل خيارًا ثقافيًا وسلوكيًا.
ولا نتحدث هنا عن الاستثناءات المضيئة، فهي موجودة في كل المجتمعات، بل عن القاعدة حين يتحول الانحراف إلى سلوك يوميّ مألوف. عندها لا يكون الفساد حادثة، بل نمط حياة.
فالانحدار الأخلاقي لا يعترف بالشهادات ولا بالمناصب. قد يشترك فيه أستاذ الجامعة مع الحِرَفي، والطبيب مع البقّال، والمهندس مع المقاول، والمفتي مع الملحد. إذ لا علاقة للعلم أو التدين الشكلي بالأخلاق ما لم يتحولا إلى ممارسة.
حين يُضرَب الأب وتُهان الأم، فذلك سقوط إنساني.
وحين تُباع الابنة لمن يدفع أكثر، فذلك ارتداد أخلاقي.
وحين يُؤكل حقّ المرأة في الميراث، فذلك عدوان صريح على العدالة.
وحين تُختزل المرأة من شريكة حياة إلى جارية، ومن إنسان كامل إلى أداة، فإننا لا نكون أمام تقاليد، بل أمام جريمة أخلاقية مع سبق الإصرار.
وحين يكتب أستاذ جامعي رسالة علمية مقابل المال، أو يصف طبيب دواءً لمصلحة شركة، أو يبيع مهندس ذمته، أو يزوّر إعلامي الحقيقة إرضاءً للسلطة، أو يعبث تاجر بقوت الناس، أو تُربط الوظيفة والعلاج بالواسطة، فذلك ليس تخلفًا تقنيًا، بل انهيارًا قيميًا.
إن الحيوان، على قسوته، لا يخون نوعه، ولا يزوّر الحقيقة، ولا يبرر الفساد. أما الإنسان حين يفعل ذلك، فإنه يتنازل طوعًا عن إنسانيته.
وهنا تتضح دلالة الآية:
﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾
أي أعلم أن الإنسان قد يسمو بعقله وأخلاقه حين يلتزم بالتكليف، وقد ينحدر بغرائزه واختياراته. والفيصل بين الحالتين ليس الهوية، بل الفعل؛ ليس ما نقوله عن أنفسنا، بل ما نضيفه إلى هذا العالم.
فالإنسان لا يُقاس بما يرفع من شعارات، بل بما يترك من أثر.
ألأرض بين الاستخلاف والإفساد
564
المقالة السابقة