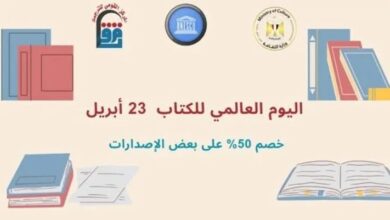مبدعات مصريات يرسمن مشهدًا خاصًا.. فنانات يغردن خارج السرب

كتب/ سيد هويدي
فنان بصري وناقد
اتخذت الإشكالية الثنائية: الرجل والمرأة، لدى العرب عامة مسارين، الأول يسعى إلى تساوي الجنسين في ظل إرث ثقافي وعقائدي، وعادات وعوائق اجتماعية واقتصادية وتشريعية قانونية، أما المسار الثاني، فهو البحث عن هوية خاصة للمرأة. وهذان المساران شهدا مراحل نضالية مضنية لإثبات الذات وانتزاع الفرص، وتحقق الفردية، والرغبة في إعمال مبدأ تكافؤ الفرص، والمساواة في الحقوق، وأحلام المستقبل المهني، وفيما يبدو أن المعركة ما زالت دائرة حتى الآن.
أما الزعيم الزنجي المناضل مارتن لوثر كنج، فيقول: “إن الطريق إلى المساواة ليس من خلال الانشقاق، ولكن من خلال الاندماج”، فمن غير المتصور أن يطرح ما يخص المرأة بمعزل عن الرجل.
فيما ظلت بعض الأصوات تردد، في ادعاء أننا إزاء مجتمع ذكوري، فالتصور الواهم أن للمرأة حقوقاً لدى الرجل، يعكس نظرة أحادية لهذه القضية. بالفعل، للمرأة حقوق، لكن ليست في مواجهة الرجل فقط، بل أمام المجتمع ككل، فمن الأجدى النظر إلى القضية على نحو أنها قضية المجتمع باتجاه الحرية المسؤولة.
خاصة أن علماء الأجناس قد قدموا البرهان القاطع على أن الفوارق الجنسية تتعلق ببعض الخواص الثانوية فقط، مما لا يسمح بإقامة حدود فاصلة بين المجموعات الإنسانية المختلفة، لذلك يقدر العلماء أن 1% فقط من مجموع الجينات غير مسؤولة إلا عن الملامح السطحية، مثل لون الجلد وما إلى ذلك. فما بالك لو أن الحديث والقياس هنا، هو الرجل والمرأة؟ لذا ليست هناك ثمة فروق فردية في القدرات، ومستوى الذكاء والإبداع أيضاً.
وإذا كانت هناك فروق، فمرجعها إلى عوامل تاريخية، اكتسب من خلالها الرجل خبرات تراكمية بحكم طبيعة دوره خارج البيت، بينما حكم التاريخ في أحيان كثيرة على المرأة أن تظل حبيسة الجدران بسبب طبيعتها كأنثى، أو كأم. فيما أعتقد أن الحل الأصيل للإشكالية، لا يمكن تحقيقه عن طريق وضع الرجل والمرأة بعضهما في مواجهة بعض، بل في توحيد قواهما التقدمية.
وعلى الرغم من أن الفنانات المصريات اللاتي شكلن الرعيل الأول ينتمين إلى أصول أرستقراطية وطبقات اجتماعية مخملية، حتى قبل إنشاء الأمير يوسف كمال مدرسة الفنون الجميلة في العام 1908، إلا أنهن وبشكل عام ارتبطن بقضايا المجتمع. فقد رسمت تحية حليم (1919-2003)، وكأنها تلون بتراب الأرض، وأصبحت الفلاحات هن موضوع عفت ناجي، وتعرضت إنجي أفلاطون للاعتقال بسبب انحيازها للفقراء.
فيما استقلت خديجة رياض (1914-1982) آلة الزمن لتبشر بقيم جمالية تجريدية تفاجئ بها المجتمع. فتحت مارجريت نخلة نافذة على مشاهد من الحياة الأرستقراطية، كما رسمت التجمعات في عشق، لتظل لوحة البورصة واحدة من أهم الأعمال في القرن العشرين.
وتقتسم عفت ناجي (1912-1994) هموم وأعباء البدايات مع زوجها سعد الخادم، وأصبحت الفلاحات موضوعها الأثير.
أما مرحلة ما قبل إنشاء مدرسة الفنون الجميلة في درب الجماميز، فنظراً لندرة التوثيق الفني والتاريخ الثقافي، فالمعلومات قليلة وشحيحة، فيما برزت أسماء فتحية ذهني، زينب عبده، والأميرة سميحة بنت السلطان حسين كامل.
كما أن الفنانات أبناء الطبقة الوسطى عبرن عن الواقع بصدق، فاحتضنت زينب عبد الحميد (1919-2002) البيوت في لوحاتها بحيوية، لكنها صورت البيوت من منظور عين الطائر، وارتبطت جاذبية سري بمظاهر الواقع الشعبي في الحارة والشوارع الضيقة، ورسمت رتيبة مع بناتها، والألعاب الشعبية، فيما تمسكت كوكب العسال بالألوان المائية، معبرة عن الطبقة الوسطى بشاعرية.
ويتواصل عطاء الأجيال، حيث تقتصد رباب نمر (1940) في الألوان، باختيارها الرسم باللون الواحد باستثناء آخر معارضها، حيث لونت لوحاتها بالإضافة إلى اللون الواحد. فيما ارتبطت مريم عبد العليم عبر مسيرتها الفنية بالحرف العربي، بينما حروفية نعيمة الشيشيني تشابهت مع بقايا نقوش تراثية أو رسوماً لحضارة قديمة.
وجاء الفن الشعبي عنواناً للوحات سوسن عامر، وذهبت فاطمة العرارجي (1931) في لوحاتها إلى عالم ميتافيزيقي، يبحث فيما وراء الطبيعة، لكن برسوم شاعرية، تعتمد على اختزال الشكل وتكثيف المعنى، من خلال علاقات حوارية لعناصر وشخوص ورموز عضوية تسبح في فراغ افتراضي رحب في ظل توازن بسيط، وبعيداً عن الافتعال.
فيما تمسكت عايدة عبد الكريم (1926) بالواقعية في نحتها الزجاجي عندما قدمت الفلاحة على طريقة محمود مختار. أما ليلى سليمان فجاءت أعمالها على نحو تعبيري، وعبرت زينب السجيني عن الأمومة، وكانت سرية صدقي (1946) قد بدأت حياتها الفنية بالنحت، ثم تحولت إلى الرسم.
وفيما تمسكت وسام فهمي (1939) بروحانية العمل الفني، اقتربت فنانات من التجريد الغنائي، منهن: ملك أبو النصر (1934)، ليلى عزت (1935)، هدى خالد (1944).
من جيل الوسط، اتجهت إيفلين عشم الله إلى الرمز، ورسمت نازلي مدكور (1949) السماء على حافة الصحراء، واختارت أزميرالدا حداد (1949) الفسيفساء، وعطيات سيد أحمد (1935) الطبيعة الصامتة، على نحو تعبيري فريد، فرسمت الموجودات من حولها بما في ذلك أدوات المطبخ، والآلات، في اختيار دقيق ومدهش.

وجمعت سهير عثمان بين تقنيات الجرافيك المركبة والمتعددة وإمكانية خلق مفهوم جديد للنسيج، فيما اختارت زينب سالم (1945) التعبير بالطين، على نحو مفاهيمي يقترب من أحدث التيارات العالمية، فيما جاءت أعمال ميرفت السويفي على نحو تعبيري يتجاوز المألوف من حيث القيمة والحجم.
واستخدمت هدى مراد اللون بكثافة، في الوقت الذي استغرق البحث عن التقنيات كل من ماجدة الشرقاوي ومديحة متولي، وانشغلت سوسن أبو النجا (1955) بالزخارف الشعبية.
وتقترب دينا الغريب من توجهات مدرسة البوب آرت، عندما استخدمت وسائل الميديا والتعبير اللحظي، وتتعلق فاتن النواوي بالأسطورة والخيال من وحي تراث عريق، وبحثت ثناء عز الدين عن التراث أيضاً لتصل إلى صيغ مقنعة لتناول الوحدات التراثية في موضوع شائك.
أما المجال الثاني الذي أقبلت عليه المرأة كوسيط إبداعي فهو الخزف. ومن السهل التعرف على تميز ميرفت السويفي (1951)، وأيضاً زينب سالم في تجاوزها مفاهيم دائرتها الأكاديمية.
فيما جعلت ليلى السنديونى (1935) من الخزف أيقونة حضارية تعكس طبقات مصر الحضارية، لكن بنعومة التصميم وحب التفاصيل.