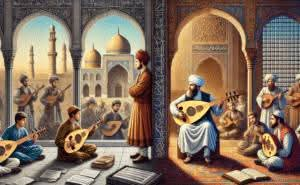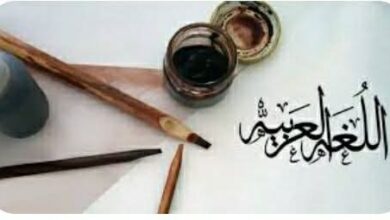زرياب مؤسس المطبخ الاندلسي
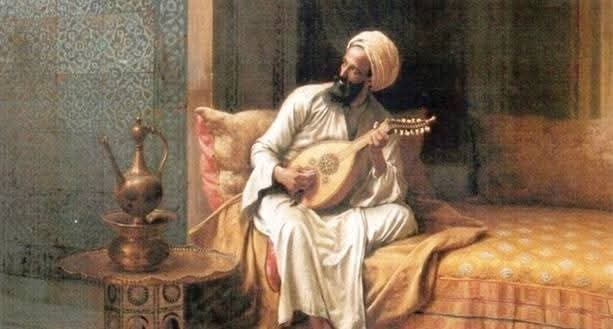
د/احمد حشيش
المطبخ في حضارة الإنسان مرآة للوضع الاقتصادي؛ فكلما مالت الحياة إلى البدائية والبساطة أثّر ذلك في مطاعم الناس، وكلما مالت الحياة إلى التعقيد تلوّنت موائدهم. ولقد كان طعام العرب في البادية مشابهًا لحياتهم البريّة جافًّا وقاسيًا، قليل التزويق والمعالجة خاليا من التعقيد
جمعوا بين موائد الروم والفرس والمغني زرياب يؤسس المطبخ الأندلسي المغربي.. تعرف على فنون الطهي في الحضارة الإسلامية
جاء في كتاب ‘أدب الكاتب‘ لأبي بكر الصُّولي (ت 339هـ/950م) خبر مناظرة بين فارسيّ وعربيّ عند الوزير العباسي الفارسي يحيى بن خالد البَرْمَكي (ت 190هـ/806م)، فكان مما خاطب به العربيَّ الفارسيُّ قولُه: “ما احتجنا إليكم قَطُّ في عمل ولا تسمية، ولقد مَلَكْتُم فما استغنيتم عنا في أعمالكم ولا لغتكم، حتى إن طبيخكم وأشربتكم ودواوينكم وما فيها على ما سمّيْنا، ما غيرتموه! فقال الأعرابي: اصبر لنا نملك كما ملكتم ألف سنة بعد ألف سنة كانت قبلها، [فإننا بعدها] لا نحتاج إليكم ولا إلى شيء كان لكم”!!
تبدو هذه المناظرة جزءا من المناكفات الشعوبية التي سادت أحيانا المجتمع الإسلامي في قرون الاحتكاك الثقافي والحضاري الأولى، لكنها أيضا كانت تعبر عن كيفية تلاقي الثقافات وأذواق الأعراق داخل مطبخ الحضارة الإسلامية، كما أن هذه المحاججة بين العربي والفارسي تشير إلى الوعي بأطوار الإبداع الحضاري الذي يبدأ تقليدا واتباعا ثم ينتهي تفردا وإبداعا. فقد كانت الحضارة الإسلامية هي “الطاهي” الذي صهر في أفرانه التفاعلية خبرات الأمم والثقافات التي طوتها، وكانت هي -في كلياتها العليا- مزيجا من مكوناتها الحضارية ومنتَجات شعوبها الثقافية.
وبقدر ما أن هذا المدخل جيد ومفيد لفهم التحولات الفكرية والمعرفية؛ فإنه كذلك أكثر إفادة لمعرفة تاريخ الطهي وثقافة الطبيخ وتحولاتها عند المسلمين، من مُبْتداها عند العرب في بوادي تِهامة ونَجْد إلى منتهاها في المراكز الحضارية على امتدادها من غانة إلى فرغانة! حيث تعتبر مسيرة تطورات الطبخ في الحضارة الإسلامية أحد الأمثلة الثقافية الشارحة لآليات التلاقي والتأثير داخل مكونات هذه الحضارة.
فالمطبخ في حضارة الإنسان مرآة للوضع الاقتصادي، وهو كذلك انعكاس لطبيعة مزاجه وثقافته، فكلما مالت الحياة إلى البدائية والبساطة أثّر ذلك في مطاعم الناس، ومهما مالت الحياة إلى التعقيد تلوّنت موائدهم. ومن هنا كان طعام العرب في البادية مشابهًا لحياتهم البريّة جافًّا وقاسيًا، قليلَ التزويق والمعالجة خاليا من التعقيد، فقائمة طعام العربي في باديته ليست إلا إحصاء لما يحيط به من النباتات والحيوانات، بل إنه كان محدود التسمية بحيث جاءت أسماء كثير من أطعمة العرب على وزن «فعيلة» كالسَّخِينة والعصيدة.
لقد كانت خيارات العرب في الطعام محدودة للغاية، ولم تكن فيها للمتعة فرصة إلا في أيام اليسار والخِصب وهي قليلة، أما في أيام الجَدْب والقحط -وهي الأغلب- فإن العرب كانوا يأكلون “كلّ ما دبَّ” على وجه الأرض؛ فلما جاءت الفتوح الإسلامية لبلاد الشام والعراق كان لها -ولما تبعها من احتكاك بالحضارات القديمة- أثر كبير على ثقافة الطعام وفنون وطرق الطهي عند العرب، إذْ استفاد المطبخ العربي من الانفتاح على الحضارتين الرومانية والفارسية أفضل ما فيهما في هذا المجال.
وبحسب المؤرخين؛ فإن عصر الأمويين غلب عليه التقليدُ والانبهار والإقبال على أطايب المطعوم والمشروب، ثم تطورت العلاقة مع الطعام في أيام الدولة العباسية فبدأ المطبخ يأخذ أشكالا من التفنن والإبداع، ولم يعد يكتفي بالنقل الحرفي للجوانب الفنية في أسس الطبخ لدى الآخرين، بل إن أصحابه تجاوزوا الوصفات المطبخية فتعمقوا في عوائد الموائد ومنافع ومضارّ الأطعمة والأشربة، ووضعوا التصانيف التي تنقل أسرار وأمزجة الطبخ وتتعمق في فهم علاقة الأغذية بصحة الجسم، كما وثّقوا أساليب التطبيب بالطعام وطرائق الطهي الصحي.
وفي عهود التألق الحضاري التي سادت فيها ثقافة “حماية المستهلك” كما جسدتها وظائف جهاز الحِسبة؛ فعّل المسلمون نُظُم الرقابة الدقيقة على المطاعم لمكافحة أنواع الغش في الغذاء، وفرضوا إجراءات نظافة صارمة للأواني التي يحضّر فيها الطعام وكذا نظافة صانعه. وفي هذه المقالة؛ ندعو القارئ الكريم ليذوق معنا -بـ”لسان” عقله- طيبات ما وقفنا عليه من مطالعات في فنون الطهي عند المسلمين، ندعوه إلى مائدة تضم ألوانًا من الأخبار والأفكار المتعلقة بالمطبخ العربي وتطوره عبر القرون، من أيام الجاهلية وصولًا إلى آخر ما طالعناه من كتب الطبيخ في القرن السابع الهجري/الـ13م.
مائدة فقيرة
عاشت أغلبية العرب في بيئة صحراوية مجدبة؛ ولذلك فإن غاية ما عرفوه من صنعة الطعام: “الثريدُ” وهو خبز يُفتّ ويبلّ بالمرق ويوضع فوقه اللحم؛ والشواء الذي منه ما يُشوى على الحطب والفحم، ومنه ما يُشوى على الحَجَر المُحْمَى بالنار، وهذا الأخير يسمونه “المَرْضوف”.
ومن ذلك طائفة من الوجبات التي تتشابه في بساطتها كما تتشابه في الصيغ الصرفية لأسمائها، حتى قال فيها أبو منصور الثعالبي (ت 429هـ/1039م) في كتابه ‘فقه اللغة وسرّ العربية‘: “وأطعمة العرب على [وزن] «فعيلة» كالسخينة والعصيدة.. والحريرة”؛ وكذلك الهريسة و”المَضيرة” وهي طبخ اللحم باللبن الماضِر أي الحامض.
وأما “الحَريرة” فيُعرِّفها مجد الدين ابن الأثير (ت 606هـ/1209م) -في ‘النهاية في غريب الحديث والأثر‘- قائلا: “الحريرة: الحَسا المطبوخ من الدقيق والدسم والماء؛ وقد تكرر ذكر الحريرة في أحاديث الأطعمة والأدوية”. وقد تطورت الحريرة مع التحضّر حتى أصبحت بصورتها الحالية التي يتفنن فيها المغاربة ويقدمونها على موائد إفطارهم الرمضانية.
ومن تلك الأطعمة البسيطة أيضا “الخَزِيرة”؛ وعن طريقة تحضيرها والفرق بينها وبين العصيدة يقول ابن منظور (ت 711هـ/1311م) في ‘لسان العرب‘: “الخزيرة والخَزِير: اللحم.. يُؤخذ فيُقطّع صغارا في القِدْر، ثم يُطبخ بالماء الكثير والملح، فإذا أُمِيَت طبْخاً ذُرَّ عليه الدقيق فعُصِد به، ثم أُدِم بأيّ إدام شِيءَ. ولا تكون الخزيرة إلا وفيها لحم، فإذا لم يكن فيها لحم فهي عصيدة”.
ولم يكن العرب يعدلون باللحم شيئًا إذا توفروا عليه، ويرون أن تناوله مع غيره تطويلٌ لا موجب له؛ فقد جاء في ‘محاضرات الأدباء‘ للراغب الأصفهاني (ت 502هـ/1108م) أنه “قُدّم إلى أعرابي خبز عليه لحم، فأكل اللحم وترك الخبز وقال: خذوا الطبق”!
ويروي ابن قتيبة الدِّينَوَري (ت 276هـ/889م) -في ‘عيون الأخبار‘- أنه “قيل لأعرابي: ما لكم تأكلون اللحم وتدعون الثريد؟ فقال: لأن اللحم ظاعن . راحل) والثريد باقٍ”!! وكان أطيب اللحم لديهم ما اختلط بعظم، حتى قال قائلهم إن “أطيب اللحم عُوّذُه، أي أطيبه ما ولي العظم كأنه عاذ به”؛ كما يقول الدينوري.
طعام اضطراري
ثم اعلم أن ما قدمنا ذكره من الأطعمة ليس من القائمة المعتادة وإنما هو طعام الموسرين من الحضر ومَن أخصبَ من أهل البادية، فإذا أجدبوا فإنهم يأكلون كلّ ما دبَّ ودَرَج؛ ففي ‘عيون الأخبار‘ أيضا أن مدنيا سأل أعرابيًا: “ما تأكلون وما تدَعُون؟ قال الأعرابي: نأكل ما دبّ ودَرَج، إلا أم حُبَيْن . الحِرْباء)”! يقال إن الجوع أطيب التوابل؛ ولذلك ففي حالة الجدب يأكل العربي ما تيسر له، حيث يكون تناول الطعام سبيلًا للنجاة لا مادة للتفكّه.
ولتكرر مواسم الجدب؛ اكتسب العربي عاداتٍ غذائية فريدة، أولاها المبادرة في اللقم؛ فالدينوري يروي أنه سُئل أعرابي: “ما تُسمُّون المرق؟ قال السَّخين، قيل له فإذا برد، قال لا نتركه يبرد”! كما أنهم كانوا يستقبحون أطعمة أنَفَةً منهم، ومن ذلك مخّ الخروف؛ فقد “قيل لأعرابيّ أتُحسِن أن تأكل الرأس؟ فقال: نعم، أبخص. أقتلِع) عينيه، وأسحي. أقشّر) خديْه، وأفكّ لحييْه . فكّيْه)، وأرمي بالدماغ إلى من هو أحوج مني إليه”
ومن ذلك أيضا كراهيتهم ما كان أهل الحضر يستطيبونه من أنواع الإدام مثل “الكامَخ”؛ فقد روى أبو حيان التوحيدي (ت بعد 400هـ/1010م) -في ‘البصائر والذخائر‘- أنه “قُدِّم إلى أعرابي كامَخٌ، فقال: مِمَّ يُعمْل هذا؟! قالوا: من اللبن والحنطة! قال: أصلان كريمان، لكنهما ما أنجبا” نِتاجا طيباً!! وجاء في ‘شرح مقامات الحريري‘ لأبي العباس أحمد بن عبد المؤمن القَيْسي الشَّرِيشي (ت 619هـ/1222م) أنه “قُدِّم لأعرابيّ كامَخٌ فلم يستطبه، وأكل منه شيئا وخرج ودخل المسجد والإمامُ في الصلاة يقرأ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾؛ (سورة المائدة/الآية: 3)، فقال الأعرابي: والكامَخ، لا تَنْسَه أصلحك الله”!!
فإن أدركتكَ شفقةً عليهم فأبشّرك بأنهم لم يكونوا يشعرون بتعاستهم، لأنهم لم يعرفوا غيرها، وإنما تجري التعاسة مع المقارنة ووجود البديل. وقد سُئل أحد بني أسد عن معيشتهم في البادية، فأجاب سائله جواب الراضي: “طعامنا أطيب طعام وأهْنَؤُه وأمْرَؤه. أطيبه)، الغثّ. نوع من الخبز)، والهَبِيد. حب الحنظل)، والفَطْس. حبّ الآس)، والعَنْكَثُ. نبات)…، والعِلْهِز . دم الجمل ووبره المشوي)، والعراجين. نوع من الكمأة)، والضِّباب . جمع ضبّ)، واليرابيع والقنافذ والحيات؛ فما أرى أن أحدًا أحسن منا عيشًا وأرضى بالًا”!!
وقد وجد الشعوبيون من الفرس في هذا مطعنًا على العرب، حتى إنه نقل أبو حيان التوحيدي -في ‘الإمتاع والمؤانسة‘- عن كاتبهم الوزير الساماني محمد بن أحمد الجَيْهاني (ت 375هـ/986م) إن العرب “يأكلون اليرابيع والضِّباب والجُرْذان والحيات..، وكأنهم قد سُلخوا من فضائل البشر، ولبسوا أُهُبَ جلود) الخنازير، ولهذا كان كسرى يسمّي مَلِكَ العرب «سَكَان شاه»، أي ملك الكلاب. وهذا لشبههم بالكلاب وجرائها.